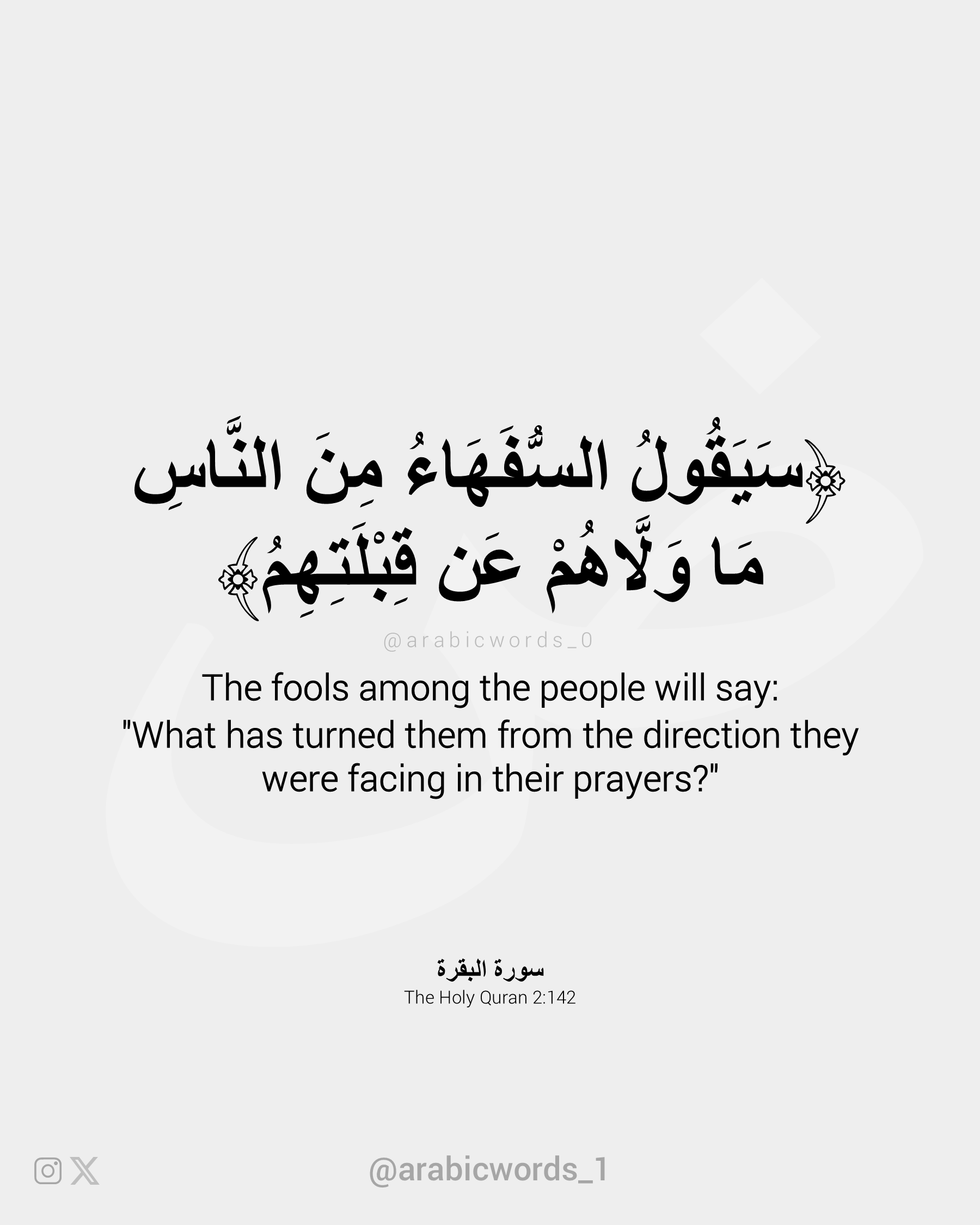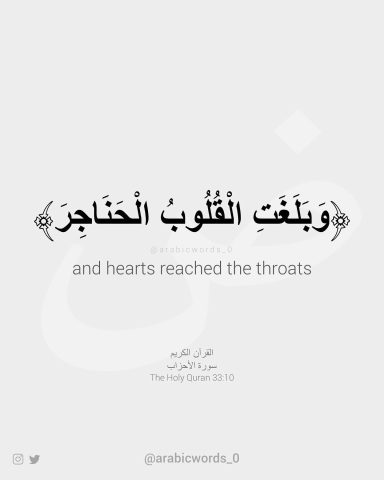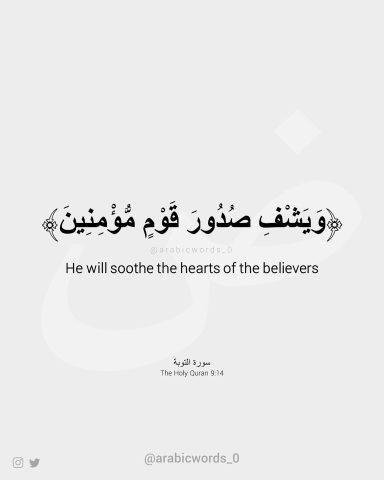تسجّل هذه الآية نموذجًا من الانتقادات التي كانت تُوَجَّه للدَّعْوة النبوية دون وجه حق. فبعد الهجرة إلى المدينة بمُدّة، نزل الأمر الإلهي بتغيير القبلة من المسجد الأقصى (الذي هو قبلة اليهود أيضًا) إلى المسجد الحرام. وابتدَر القُرآن ما سيقوله "السفهاء" فردّ عليهِم بأن المشرِق والمغرِب لله، وأن القبلة الأولى لم تَكُن سوى ابتِلاء لِكَيْ يتبيّن "من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه".
هذه الحادثة تكشِفْ لنا عن سُنّة تاريخية تواجِه الحَرَكات الإصلاحية عمومًا، بما فيها الدعوات النبوية، ألا وهي أن هذه الحركات دائمًا ما تكون محل تربُّص شديد. وكُلّ فِعْل يأتي به القادة لا بُدّ أن يتحوّل إلى اتِّهَام. سواء كان في أمرٍ عبادي بين الخلق وربهم كتغيير اتجاه الصلاة، أو في وقفةً كُبْرى في وَجْه الطُّغيان، كمن اتهموا قيادة النبي (ص) بعد غزوة أحد فقالوا: "لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا"، أو كمن قال عنهم أمير المؤمنين (ع): "فإن أقل يقولوا حرص على الملك، وإن أسكت يقولوا جزع من الموت". حالة التربُّص هذه كأنها سُنّة ثابتة لا بد أن يكون المُصلح مترقّبًا لحدوثها ومستعدًا للرد عليها، وهي رد فعل متوقّع ممّن يريدون أن تستمر حالة التخدير التي تكون الأمم غارقة فيها عندما يأتي المُصلِحون.
وبالأمس القريب نذكر كيف كان البعض لا يعجبهم إسناد الحزب، ويسخرون منه، حتى إذا دخل الحرب قالوا سيجلب الدمار، فإذا خرج منها قالوا خذلوا إخوانهم. وكلّما اتبعت المُقـ//ومة تكتيكًا جديدًا، خرج السفهاء ولسان حالهم "ما ولاهم عن قبلتهم؟"
يضع القُرآن معيارًا للمؤمنين المصلحين يحكمون به على الأمور. فيقول أوّلًا أنه يجِب أن تفهم حقيقة الاتهامات، هل هي نقد بنّاء أم اتّهامات مغرضة؟ في هذه الواقِعة، لم تكن القبلة سوى ذريعة للانتقاد، ولم يكن هؤلاء الطاعنون سيتبعوا محمدًا (ص) مهما فعل:
"ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض"
ثم يلتفِت إلى المؤمنين فيقول لهم أن تغيير المظاهر وارد الحدوث، وتغيير الحال أيضًا وارد الحدوث، بل إنه آتٍ لا محالة، فقد أتى القُرآن بعد بضع آيات ليقول للمؤمنين:
"ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات"